"شادي سمحان" : لفظتهُ الحياة .. فتحوّل إلى صناعتها!
عمان جو - بثينه السراحين
وُلد عريانا من الحظ ،، فلم تسترهُ ثروة أبيه، أو يواريه جاه عشيرته،، مسكونٌ بخطيئة الحضور للدّنيا في زمن صعب لا ترحم خطوبه الأشقياء مثله،، تلقّف 'شادي سمحان' صدمة الحياة مذ تفتّح وعيه،، فتناول وجبته الدسمة من الألم قبل أن تلقمهُ الحياة كُنه المعرفة والإدارك لكيفية معالجة كل إرتدادات هذا الألم على روحه التي أطبقت عليها كفوف الخيبة والإنكسارات. والحياة لم تلفظهُ فحسب،، بل عاندته حدّ أنّهُ حار في السؤال طفلا؛ عن أيّ كفارة يمحو بها ذنوب ضعفه وسحقه التي لاحقته سنيّ طوال؟!،، فلا النحس يُهادنه،، ولا الدنيا تمنحهُ إستراحة المحارب ،، فأيّ كفارة هذه التي نمحو بها خطيئة وجودنا في عالم يضيق بنا ولا حيز لنا بين مُترَفيه،، يتساءل شادي طفلا؟!. ومتعثرا قضى شادي أوّل العمر،، ليشكّل في ذاكرته البِكر وجهَ طفولته المشوّهة،، طفولة كانت عصيّة على البراءة،، سخيّة على الشقاء والمعاناة،، فلم تشفع لهُ 'شطارته' أو 'شقاوته' في مكابدة ويلات مستهلّ العمر. وبعيونٍ تبرِقُ بدموعٍ تحبسها رجولة سكنته مذ أول وهله رأى فيها النور، يصف شادي نفسه' كنت طفلا شقيا (شاقّ الأرض وطالع منها)، وربما هي مؤهلات خصّتني بها أقداري لتمكيني من بذل طاقة غير محدودة على تحمل حياة كانت خالية من ملامح الطفولة؛ دلعها وملابسها الزاهية وأحلامها التي سقفها لعبة مسلية أو رحلة شيّقة'.
على النقيض من ذلك، يقول شادي، ولدتّ كبيرا بما يتّسق وحجم المسؤوليات الجمّة التي كانت في إنتظاري ولم تمنحني متّسعا لأعايش مراحل العمر على نحو طبيعي،، فالفقر برَع في حرقِ مراحلِ العمر،، وفي توجيه بوصلته سريعا نحو قضائه في العمل والبحث عن أسباب البقاء،، فالبقاء وحده كان أسمى غاياتي في مرحلتيّ الطفولة والصبا، وحتى عهد قريب من مرحلة شبابي؛ التي أعايشها اليوم مسكونة بوجع الماضي الذي يراوح مكانه حتى اللحظة في الروح والذاكرة.
ويتذكر شادي كلمات والده التي أسّس له من خلالها خطّاً ونهجاً للحياة (عليكَ بالعمل لتعرف قيمة القرش الذي تعتاش به)!!، وليبدأ بعدها، وفي سن السادسة تحديدا، بجني ثمن قوته و تأمين كُلفة حياته وضمانات استمراره،، وفي ذلك يقول' عايشتُ قسوة تجربة عمالة الأطفال بكل ما تنطوي من أسئلة حائرة في البال،، أسئلة لا تزال مُشرَعة لجهة تقصّي إجابة ضلت طريقها للتبرير والمواساة،، لماذا حُرِمتُ طفولتي؟ وما ذنبي الذي اقترفته لكي أفقد حقي في معايشتها بكل تفاصيلها الحلوة؟!،،، سؤال لا يزال يلحّ عليّ حتى اللحظة ، ولا يزال معلقا برسم إجابة لن تكون بأي حال شافية بما يردّ عني إحساسات الظلم والحرمان'. خلال سنتهِ الدّراسيّة الإبتدائية الأولى، بدأ شادي يجوب شوارع حارته الكائنة في حي الأشرفية، بُعيد إنتهائه من تلقّي دروسه كل يوم،، ولا يَهمّ التعب أو الجوع الذي يكابده،، ولا ضررَ من مقاومة شهيّته لمشاركة أقرانه في لعبة (طُبّة الشرايط) أو (الجلول – البنانير)،،فالأهم هو أن ينجح قبل حلول الظلام في بيع كل حبات (الحلاوة) وأكياس (الترمس) التي توفر دخلا إضافيا لعائلته الصغيرة ؛ ممّن يعملُ ربّ أسرتها في مهنة موسميّة هي 'الحياكة'، والتي يزداد الطلب عليها في مواسم الأعياد ومع بدايات العام الدراسي وشهور الصيف،، وسرعان ما يتراجع الطلب عليها بقية شهور السنة، ليتحوّل الوالد إلى شبه عاجز عن الإعالة!. للإنصاف، يكشف شادي، لم أكن وحدي من أبتلي بعمالة الأطفال، فقد قاسمني شقيقي 'شكري' الذي يكبرني هذا الشقاء، ولهذا كان ولا يزال صديقي المقرّب حتى اللحظة،، ربما لأنه يختزن في ذاكرته كل تفاصيل حقيقتي التي لا أجد اليوم فيها إلا كلّ ما يشرّفني ويدعوني للمفاخرة؛ حقيقة أنّ المحِن هي من تصنع الرجال،، وأنّ الرجال هُم من يجنونَ المال ويوفّرون أسباب الحياة،، لكنّهم يتعففون عن طلبها وتلقّيها في قوالب جاهزة،، هذا ما علمتني إياه والدتي الطيبة،، فيما كان والدي يواصل تحفيزه لي على تمثّل الصبر والجلد والصمود في وجه ظروفنا غير المواتية.
تنقّل شادي من العمل في بيع الترمس والحلاوة والبليلة إلى بيع 'سحبة البلالين' في سنته التاسعة، فالذرة المسلوقة في سنّ الحادية عشرة، وهي التي استحدث وشقيقه لها وسائل أكثر تطوّرا!!؛ صندوق خضار خشبي فارغ يتم وضعه بين (بيلات) إطارات مهترئة لمركبة استعاض مالكها عنها باطار جديد، ليمنح شادي وأمثاله أدوات لتطوير وسائل العيش والترزّق،، ولتتشكل بذلك عربة ذرة تشمل بالطبع (بابور كاز) يُبقي عليها ساخنة وشهيّة، بما يكفي لجذب الزبائن، وجني ثمن البقاء لبائعها الصغير. ظروف بدائيّة لعمالة 'جائرة' في سنٍ حرجة لا تحتمل كل هذا الظلم والشقاء، خاصة وأنّ غريزة الإنسان في مثل هذه المرحلة العمرية وتكوينه النفسي ينزعان لجهة تلقّي الرعاية والتضحيات، وليس لمنحها أو بذلها،، والحالُ كذلك كان شادي ولا يزال يستشعر حزنا عميقا لا يجد له دواء أو شفاء،، ويوضح' يكفيني أنني كنتُ عرضةً لسخريّة أقراني،، ينظرون لشقائي فيحتقرونني،، وأنظر للهوهم ومرحهم ولعبهم؛ فأستشعر النقيصة في نفسي والذلّ في روحي، والحسرة تشتعل في قلبي'.
وتفيضُ ذاكرة شادي عن مزيد من مشاهد طفولة معذبة' كنتُ أقضي الليل أعجز عن النوم؛ محاولا إستحضار تفاصيل رحلة مدرسيّة تنعّم بها أقراني لمدينة البتراء، أو العقبة أو وادي رمّ،، أسهر الليل محاولاً زيارة هذه الأماكن بمخيّلة عاجز عن ملامسة الحقيقة،، وحالم حدّ الجنون،، ذلك أنّ مجرّد تطلعي لمعايشة ظروف حياة طبيعية كان آنذاك ضرب من الخيال والجنون'. لم تتوقف الحياة عن معاندة شادي الطفل، ويتساءل' هل كان عدلاً أن أحقّق حُلمي بالحصول على درّاجة هوائية بعد طول إنتظار، في سنتي العاشرة، وبالشراكة مع ثلاثة أصدقاء آخرين لي تقاسمت وإيّاهم متعة اللهو بالدرّاجة التي كانت تبيتُ كلّ ليلة في منزل أحدنا وفقا لقسمة بينيّة عادلة؟!،، لكنّ العدل سرعانَ ما مالَ ميزانُه حين تحوّلت هذه الدرّاجة لوسيلة للإسترزاق لنا ونحن من نتشاطر ظرف العوز والحاجة،، فكانَ أنْ بدأنا بتأجيرها لأبناء الحارة (الشوط بشلن)،، و(الشوطين بعشرة قروش)،، كانت مهزلة قدريّة بكل معنى الكلمة أن تبيع طفولتك للآخرين!!!'.
والمهزلة تعدّدت أوجهها، وتنوّعت نكهاتها في حلق طفولة شادي،، ممّن يصرّ على 'أنّ أكثر ما يوجعني هو تساؤلي في طفولتي عن سبب حرماني من حقي بامتلاك دراجة هوائية تكون لي وحدي وأستخدمها للمرح، وليس لجلب ثمن رغيف الخبز،، فهل كانَ هذا مطلبا كبيرا؟ وهل لو تحققّ لي ذلك لتسببّت بإختلال في ميزان الكون!!!'. ويبين شادي بأنه تذوق وأشقاءهُ طعمَ الحرمان بأبشع صوره، حين أضطر والده للتوجه إلى فلسطين المحتلة طلبا للرزق،، لتستقبله ظروف سياسية واقتصادية معقدة باندلاع الإنتفاضة الأولى فور وصوله هناك!!، وفشله بالتالي في تأمين رزق عياله،، خلال ذلك العام الذي قضاه والده في محاولات بائسة ومقامرات حياتية خاسرة لجهة النفاذ من قمقم الفقر تذوق شادي وأشقائه طعم الجوع 'كنّا نقتات غالبية الوقت على (فتّة) الخبز والشاي،، وإنْ وجدنا ( زرّ) بندورة أو (حبّة) زيتونة تذوقنا النعيم في يومنا ذاك'.
وحياةُ التيه التي اتّسمت بها طفولة شادي،، لم تتوقف عندَ حدّ معين، فخلفته محروما من فرصة إكمال تعليمه ' كنتُ الأوّل على الصفّ حتى السادس إبتدائي، وحصلت على تقديرات جيد جدا حتى الصف العاشر الذي تخلفتُ خلاله عن الدراسة لوصولي لقناعة أنّني حتى وإنْ أستكملت مدرستي، سيستحيل لاحقا أن أجدَ موردا ماليّا لتمويلِ حُلمي بدراسةِ العلوم السياسة،، فكانَ الخيار الواقعي بالتفرغ للعمل ومساندة والدي لجهة توفير دخل إضافي لإعالة أسرتي'.
وربما كانت عدسة المصورين رصدته يوما وهي تلهث خلف صورة لطفل يلتقط عُلب البيبسي الفارغة،، خاصة وأنها كانت تبحث عن سبق صحفي لصورة مماثلة في بدايات تشكل ظاهرة عمالة جمع العُلب الفارغة في بلد توحّش فيه الفقر فأفترس كرامة الراشدين وبراءة القاصرين إلا مَنْ عفى عنهم ربّي،، ولأنّه لم يكن معفيّا من الشقاء جمع 'شادي' الخردة والعُلب الفارغة في مرحلة صباه وبالتشاطر مع شقيقه شكري،، كما عمل في مصنع أحذية لم يحتمل الإستمرار فيه طويلا بسبب روائح (الآغو) و(التنر) التي كانت تنبعث بقوة من الأحذية ،، هذه المواد التي لطالما كان ضحيّتها أطفال ومراهقين عرفوا طريقهم للإدمان عليها جرّاء عمالتهم المبكرة وتخلفهم عن الدراسة وغياب التوجيه،، إلا أنّ شادي وشقيقه كانا محظيّان بيقظة الوالد' إيّاكم وأخذ سيجارة من أحد وتدخينها،، وإياكم ورفاق السوء،، ابتعدوا عن الزعران وأرباب السوابق ولا تحتكوا بهم'. وكان شادي غير معنيّ في الواقع إلا بالعمل لدرجة انه انطبق عليه في مرحلة ما المثل القائل (سبع صنايع والبخت ضايع)،، ففي مرحلة ما امتهن خدمة التوصيل للزبائن لصالح مطعم فول وحمص،، ليكابدَ إرهاقا بدنيّا لا يوصف عبر السير لساعات طويلة على الأقدام تلبية لرغبات الزبائن التي لا تنتهي إلا وهي تكاد تُجهزُ عليه في آخر كل يوم عمل شاق. ومن شقاء إلى آخر يفوقه؛ انتقل شادي للعمل في مخبز،، ثم بائعا للملابس المستعملة (البالة) في سوق الجمعة، كما عمل بائع خضار متجول، و من ثم بائعا للورود التي تفنّن في تنسيقها ليهب الآخرين من خلالها فرحا لم يتذوّقه،، وترفا اسمه الحب لم يجد لديه وقتا ليعايش قصصه كبقية أقرانه.
في فترة لاحقة تيّقن شادي من ضرورة تعويض ما فاته من فرص للعيش الكريم من خلال تحصيل شيء من العلم بما يخوّله للحصول على وظيفة تريحه من شقاء العمالة التي لاصقته منذ طفولته المبكرة، فحصل في سن السادسة عشرة على دورة في التصميم على جهاز الحاسوب من معهد التدريب المهني. فور إنتهائه من الدورة التعليمية التي اجتازها بإمتياز وشهادة تقدير اعتقد شادي أنّ الحياة فتحت ذراعيها له أخيرا، فكانت المفاجأة غير المتوقعة' استغلني صاحب مركز مختص بالتصميم على الكمبيوتر توجهت للعمل لديه في هذا التخصص، لأفاجأ به يعيدني للعمالة مرة أخرى، ويمنحني وظيفة (مراسل)!! أعدّ االقهوة والشاي له ولبقية الموظفين،، ويطلب مني غسل الصحون وتنظيف المرحاض!!، وكلّ ذلك كان دافعه يقينه بأنني بحاجة ماسة للعمل، فدفعه جشعه لإستغلالي إلى أبعد حدّ؛ من جهة نوع العمل الذي طلبه مني، وكذلك الراتب الذي حدده لي؛ ستون دينارا فقط في الشهر!!'. كان المركز المذكور يقع في منطقة ماركا الشمالية،، يقول شادي بمرارة، وكثيرا ما كنت أغادره بعد إنتهاء عملي فيه وأنا لا أمتلك قيمة أجرة ركوبي إلى منزلي في حي الأشرفية، فأضطر للعودة إليه مشيا على الأقدام،، كنتُ أسير لما يزيد على ساعات ثلاث،، أحيانا تتخللها أمطار قاسية، وذكريات أكثر قسوة تستحضرها مسافة السير الطويلة عن طفولة شقيّة تعرضت خلالها للمرض ولملازمة الفراش لعدة أيام بسبب إنهيار جسدي الغضّ أمام أعباء عمل مضن ومرهق.
ذكريات من جوف الماضي،، وأحلام متعثرة في غياهب المجهول، كانت تتزاحم في عقل شادي خلال رحلة شقائه من مكان عمله في ماركا إلى حيث منزله المتواضع في 'الأشرفيّة' وأهله الطيبين،، وما هي إلا ثلاثة أشهر في العمل بمركز ماركا قضاها الحلم في مخاض عسير، أعقبها ولوج هذا الحلم لدفّة الواقع ولأول مرة ' حصلتُ على فرصة للعمل في مهنة صفّ الحروف في صحيفة الشاهد الأسبوعية،، وسرعان ما حزتُ على ثقة ناشرها العمّ (أبو معاذ) ممّن منحني سريعا ترقية وظيفية بأن مكنني من العمل كمخرج صحفي، ولأصبح بعدها رئيسا لقسم الإخراج الصحفي في 'الشاهد'، كما كان لعملي لدى أستاذي 'صخر أبو عنزة' فضل كبير عليّ لجهة حصولي على خبرة في فن الكتابة الصحفية،، ولأتقلد لاحقا منصب مدير وكالة رمّ الإخبارية'.
خلال عمله في 'الشاهد'، حصل شادي على فرص إضافية للعمل في صحف أخرى كالهلال والأنباط، والاعلام البديل، وسرعان ما حقق حلمه لجهة تأسيس مشروعه الإعلامي المستقلّ، وكان ذلك من خلال إشهاره لوكالة (عمان جو)الإخبارية، كما أشهر مجلة' الخزنة' الإقتصادية الورقية. وللغرابة أن النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا ويحصد جناه اليوم، بما حوّله إلى واحد من أبرز المنافسين في الإعلام الإلكتروني المحلي،، لم يفلح في إخماد نيران الحزن التي استوطنت روحه، فشغلتها بحالة مستعصية من إنعدام السكينة ' الفضلُ لله، ومن بعده لوالديّ في كل ما حققته،، لكنني لا زلت عاجزا عن تلمّس الفرح،، فآلآم الماضي تباغتني لتقطع عليّ وصلته كلما اقترب مني وحاول مهادنتني،، ذلك الفرح الذي عاداني صغيرا،، فخاصمته كبيرا،، والمضحك المبكي هو أنني أخجل من شادي الصغير الشقي حين أحاول إنكاره بملذات وأفراح تيسرت لي أخيرا، وبنشوة وفرتها لي ظروف النجاح وخُطى الوصول،، خطوات تسير بي في ليلي إلى الخلف السحيق،، أختلي بنفسي مع مشاهد تدمي قلبي،، ولتخذلني رجولتي في صدّ ثورة دموعي السخية وأنا أعاود إجترارها'.
عمان جو - بثينه السراحين
وُلد عريانا من الحظ ،، فلم تسترهُ ثروة أبيه، أو يواريه جاه عشيرته،، مسكونٌ بخطيئة الحضور للدّنيا في زمن صعب لا ترحم خطوبه الأشقياء مثله،، تلقّف 'شادي سمحان' صدمة الحياة مذ تفتّح وعيه،، فتناول وجبته الدسمة من الألم قبل أن تلقمهُ الحياة كُنه المعرفة والإدارك لكيفية معالجة كل إرتدادات هذا الألم على روحه التي أطبقت عليها كفوف الخيبة والإنكسارات. والحياة لم تلفظهُ فحسب،، بل عاندته حدّ أنّهُ حار في السؤال طفلا؛ عن أيّ كفارة يمحو بها ذنوب ضعفه وسحقه التي لاحقته سنيّ طوال؟!،، فلا النحس يُهادنه،، ولا الدنيا تمنحهُ إستراحة المحارب ،، فأيّ كفارة هذه التي نمحو بها خطيئة وجودنا في عالم يضيق بنا ولا حيز لنا بين مُترَفيه،، يتساءل شادي طفلا؟!. ومتعثرا قضى شادي أوّل العمر،، ليشكّل في ذاكرته البِكر وجهَ طفولته المشوّهة،، طفولة كانت عصيّة على البراءة،، سخيّة على الشقاء والمعاناة،، فلم تشفع لهُ 'شطارته' أو 'شقاوته' في مكابدة ويلات مستهلّ العمر. وبعيونٍ تبرِقُ بدموعٍ تحبسها رجولة سكنته مذ أول وهله رأى فيها النور، يصف شادي نفسه' كنت طفلا شقيا (شاقّ الأرض وطالع منها)، وربما هي مؤهلات خصّتني بها أقداري لتمكيني من بذل طاقة غير محدودة على تحمل حياة كانت خالية من ملامح الطفولة؛ دلعها وملابسها الزاهية وأحلامها التي سقفها لعبة مسلية أو رحلة شيّقة'.
على النقيض من ذلك، يقول شادي، ولدتّ كبيرا بما يتّسق وحجم المسؤوليات الجمّة التي كانت في إنتظاري ولم تمنحني متّسعا لأعايش مراحل العمر على نحو طبيعي،، فالفقر برَع في حرقِ مراحلِ العمر،، وفي توجيه بوصلته سريعا نحو قضائه في العمل والبحث عن أسباب البقاء،، فالبقاء وحده كان أسمى غاياتي في مرحلتيّ الطفولة والصبا، وحتى عهد قريب من مرحلة شبابي؛ التي أعايشها اليوم مسكونة بوجع الماضي الذي يراوح مكانه حتى اللحظة في الروح والذاكرة.
ويتذكر شادي كلمات والده التي أسّس له من خلالها خطّاً ونهجاً للحياة (عليكَ بالعمل لتعرف قيمة القرش الذي تعتاش به)!!، وليبدأ بعدها، وفي سن السادسة تحديدا، بجني ثمن قوته و تأمين كُلفة حياته وضمانات استمراره،، وفي ذلك يقول' عايشتُ قسوة تجربة عمالة الأطفال بكل ما تنطوي من أسئلة حائرة في البال،، أسئلة لا تزال مُشرَعة لجهة تقصّي إجابة ضلت طريقها للتبرير والمواساة،، لماذا حُرِمتُ طفولتي؟ وما ذنبي الذي اقترفته لكي أفقد حقي في معايشتها بكل تفاصيلها الحلوة؟!،،، سؤال لا يزال يلحّ عليّ حتى اللحظة ، ولا يزال معلقا برسم إجابة لن تكون بأي حال شافية بما يردّ عني إحساسات الظلم والحرمان'. خلال سنتهِ الدّراسيّة الإبتدائية الأولى، بدأ شادي يجوب شوارع حارته الكائنة في حي الأشرفية، بُعيد إنتهائه من تلقّي دروسه كل يوم،، ولا يَهمّ التعب أو الجوع الذي يكابده،، ولا ضررَ من مقاومة شهيّته لمشاركة أقرانه في لعبة (طُبّة الشرايط) أو (الجلول – البنانير)،،فالأهم هو أن ينجح قبل حلول الظلام في بيع كل حبات (الحلاوة) وأكياس (الترمس) التي توفر دخلا إضافيا لعائلته الصغيرة ؛ ممّن يعملُ ربّ أسرتها في مهنة موسميّة هي 'الحياكة'، والتي يزداد الطلب عليها في مواسم الأعياد ومع بدايات العام الدراسي وشهور الصيف،، وسرعان ما يتراجع الطلب عليها بقية شهور السنة، ليتحوّل الوالد إلى شبه عاجز عن الإعالة!. للإنصاف، يكشف شادي، لم أكن وحدي من أبتلي بعمالة الأطفال، فقد قاسمني شقيقي 'شكري' الذي يكبرني هذا الشقاء، ولهذا كان ولا يزال صديقي المقرّب حتى اللحظة،، ربما لأنه يختزن في ذاكرته كل تفاصيل حقيقتي التي لا أجد اليوم فيها إلا كلّ ما يشرّفني ويدعوني للمفاخرة؛ حقيقة أنّ المحِن هي من تصنع الرجال،، وأنّ الرجال هُم من يجنونَ المال ويوفّرون أسباب الحياة،، لكنّهم يتعففون عن طلبها وتلقّيها في قوالب جاهزة،، هذا ما علمتني إياه والدتي الطيبة،، فيما كان والدي يواصل تحفيزه لي على تمثّل الصبر والجلد والصمود في وجه ظروفنا غير المواتية.
تنقّل شادي من العمل في بيع الترمس والحلاوة والبليلة إلى بيع 'سحبة البلالين' في سنته التاسعة، فالذرة المسلوقة في سنّ الحادية عشرة، وهي التي استحدث وشقيقه لها وسائل أكثر تطوّرا!!؛ صندوق خضار خشبي فارغ يتم وضعه بين (بيلات) إطارات مهترئة لمركبة استعاض مالكها عنها باطار جديد، ليمنح شادي وأمثاله أدوات لتطوير وسائل العيش والترزّق،، ولتتشكل بذلك عربة ذرة تشمل بالطبع (بابور كاز) يُبقي عليها ساخنة وشهيّة، بما يكفي لجذب الزبائن، وجني ثمن البقاء لبائعها الصغير. ظروف بدائيّة لعمالة 'جائرة' في سنٍ حرجة لا تحتمل كل هذا الظلم والشقاء، خاصة وأنّ غريزة الإنسان في مثل هذه المرحلة العمرية وتكوينه النفسي ينزعان لجهة تلقّي الرعاية والتضحيات، وليس لمنحها أو بذلها،، والحالُ كذلك كان شادي ولا يزال يستشعر حزنا عميقا لا يجد له دواء أو شفاء،، ويوضح' يكفيني أنني كنتُ عرضةً لسخريّة أقراني،، ينظرون لشقائي فيحتقرونني،، وأنظر للهوهم ومرحهم ولعبهم؛ فأستشعر النقيصة في نفسي والذلّ في روحي، والحسرة تشتعل في قلبي'.
وتفيضُ ذاكرة شادي عن مزيد من مشاهد طفولة معذبة' كنتُ أقضي الليل أعجز عن النوم؛ محاولا إستحضار تفاصيل رحلة مدرسيّة تنعّم بها أقراني لمدينة البتراء، أو العقبة أو وادي رمّ،، أسهر الليل محاولاً زيارة هذه الأماكن بمخيّلة عاجز عن ملامسة الحقيقة،، وحالم حدّ الجنون،، ذلك أنّ مجرّد تطلعي لمعايشة ظروف حياة طبيعية كان آنذاك ضرب من الخيال والجنون'. لم تتوقف الحياة عن معاندة شادي الطفل، ويتساءل' هل كان عدلاً أن أحقّق حُلمي بالحصول على درّاجة هوائية بعد طول إنتظار، في سنتي العاشرة، وبالشراكة مع ثلاثة أصدقاء آخرين لي تقاسمت وإيّاهم متعة اللهو بالدرّاجة التي كانت تبيتُ كلّ ليلة في منزل أحدنا وفقا لقسمة بينيّة عادلة؟!،، لكنّ العدل سرعانَ ما مالَ ميزانُه حين تحوّلت هذه الدرّاجة لوسيلة للإسترزاق لنا ونحن من نتشاطر ظرف العوز والحاجة،، فكانَ أنْ بدأنا بتأجيرها لأبناء الحارة (الشوط بشلن)،، و(الشوطين بعشرة قروش)،، كانت مهزلة قدريّة بكل معنى الكلمة أن تبيع طفولتك للآخرين!!!'.
والمهزلة تعدّدت أوجهها، وتنوّعت نكهاتها في حلق طفولة شادي،، ممّن يصرّ على 'أنّ أكثر ما يوجعني هو تساؤلي في طفولتي عن سبب حرماني من حقي بامتلاك دراجة هوائية تكون لي وحدي وأستخدمها للمرح، وليس لجلب ثمن رغيف الخبز،، فهل كانَ هذا مطلبا كبيرا؟ وهل لو تحققّ لي ذلك لتسببّت بإختلال في ميزان الكون!!!'. ويبين شادي بأنه تذوق وأشقاءهُ طعمَ الحرمان بأبشع صوره، حين أضطر والده للتوجه إلى فلسطين المحتلة طلبا للرزق،، لتستقبله ظروف سياسية واقتصادية معقدة باندلاع الإنتفاضة الأولى فور وصوله هناك!!، وفشله بالتالي في تأمين رزق عياله،، خلال ذلك العام الذي قضاه والده في محاولات بائسة ومقامرات حياتية خاسرة لجهة النفاذ من قمقم الفقر تذوق شادي وأشقائه طعم الجوع 'كنّا نقتات غالبية الوقت على (فتّة) الخبز والشاي،، وإنْ وجدنا ( زرّ) بندورة أو (حبّة) زيتونة تذوقنا النعيم في يومنا ذاك'.
وحياةُ التيه التي اتّسمت بها طفولة شادي،، لم تتوقف عندَ حدّ معين، فخلفته محروما من فرصة إكمال تعليمه ' كنتُ الأوّل على الصفّ حتى السادس إبتدائي، وحصلت على تقديرات جيد جدا حتى الصف العاشر الذي تخلفتُ خلاله عن الدراسة لوصولي لقناعة أنّني حتى وإنْ أستكملت مدرستي، سيستحيل لاحقا أن أجدَ موردا ماليّا لتمويلِ حُلمي بدراسةِ العلوم السياسة،، فكانَ الخيار الواقعي بالتفرغ للعمل ومساندة والدي لجهة توفير دخل إضافي لإعالة أسرتي'.
وربما كانت عدسة المصورين رصدته يوما وهي تلهث خلف صورة لطفل يلتقط عُلب البيبسي الفارغة،، خاصة وأنها كانت تبحث عن سبق صحفي لصورة مماثلة في بدايات تشكل ظاهرة عمالة جمع العُلب الفارغة في بلد توحّش فيه الفقر فأفترس كرامة الراشدين وبراءة القاصرين إلا مَنْ عفى عنهم ربّي،، ولأنّه لم يكن معفيّا من الشقاء جمع 'شادي' الخردة والعُلب الفارغة في مرحلة صباه وبالتشاطر مع شقيقه شكري،، كما عمل في مصنع أحذية لم يحتمل الإستمرار فيه طويلا بسبب روائح (الآغو) و(التنر) التي كانت تنبعث بقوة من الأحذية ،، هذه المواد التي لطالما كان ضحيّتها أطفال ومراهقين عرفوا طريقهم للإدمان عليها جرّاء عمالتهم المبكرة وتخلفهم عن الدراسة وغياب التوجيه،، إلا أنّ شادي وشقيقه كانا محظيّان بيقظة الوالد' إيّاكم وأخذ سيجارة من أحد وتدخينها،، وإياكم ورفاق السوء،، ابتعدوا عن الزعران وأرباب السوابق ولا تحتكوا بهم'. وكان شادي غير معنيّ في الواقع إلا بالعمل لدرجة انه انطبق عليه في مرحلة ما المثل القائل (سبع صنايع والبخت ضايع)،، ففي مرحلة ما امتهن خدمة التوصيل للزبائن لصالح مطعم فول وحمص،، ليكابدَ إرهاقا بدنيّا لا يوصف عبر السير لساعات طويلة على الأقدام تلبية لرغبات الزبائن التي لا تنتهي إلا وهي تكاد تُجهزُ عليه في آخر كل يوم عمل شاق. ومن شقاء إلى آخر يفوقه؛ انتقل شادي للعمل في مخبز،، ثم بائعا للملابس المستعملة (البالة) في سوق الجمعة، كما عمل بائع خضار متجول، و من ثم بائعا للورود التي تفنّن في تنسيقها ليهب الآخرين من خلالها فرحا لم يتذوّقه،، وترفا اسمه الحب لم يجد لديه وقتا ليعايش قصصه كبقية أقرانه.
في فترة لاحقة تيّقن شادي من ضرورة تعويض ما فاته من فرص للعيش الكريم من خلال تحصيل شيء من العلم بما يخوّله للحصول على وظيفة تريحه من شقاء العمالة التي لاصقته منذ طفولته المبكرة، فحصل في سن السادسة عشرة على دورة في التصميم على جهاز الحاسوب من معهد التدريب المهني. فور إنتهائه من الدورة التعليمية التي اجتازها بإمتياز وشهادة تقدير اعتقد شادي أنّ الحياة فتحت ذراعيها له أخيرا، فكانت المفاجأة غير المتوقعة' استغلني صاحب مركز مختص بالتصميم على الكمبيوتر توجهت للعمل لديه في هذا التخصص، لأفاجأ به يعيدني للعمالة مرة أخرى، ويمنحني وظيفة (مراسل)!! أعدّ االقهوة والشاي له ولبقية الموظفين،، ويطلب مني غسل الصحون وتنظيف المرحاض!!، وكلّ ذلك كان دافعه يقينه بأنني بحاجة ماسة للعمل، فدفعه جشعه لإستغلالي إلى أبعد حدّ؛ من جهة نوع العمل الذي طلبه مني، وكذلك الراتب الذي حدده لي؛ ستون دينارا فقط في الشهر!!'. كان المركز المذكور يقع في منطقة ماركا الشمالية،، يقول شادي بمرارة، وكثيرا ما كنت أغادره بعد إنتهاء عملي فيه وأنا لا أمتلك قيمة أجرة ركوبي إلى منزلي في حي الأشرفية، فأضطر للعودة إليه مشيا على الأقدام،، كنتُ أسير لما يزيد على ساعات ثلاث،، أحيانا تتخللها أمطار قاسية، وذكريات أكثر قسوة تستحضرها مسافة السير الطويلة عن طفولة شقيّة تعرضت خلالها للمرض ولملازمة الفراش لعدة أيام بسبب إنهيار جسدي الغضّ أمام أعباء عمل مضن ومرهق.
ذكريات من جوف الماضي،، وأحلام متعثرة في غياهب المجهول، كانت تتزاحم في عقل شادي خلال رحلة شقائه من مكان عمله في ماركا إلى حيث منزله المتواضع في 'الأشرفيّة' وأهله الطيبين،، وما هي إلا ثلاثة أشهر في العمل بمركز ماركا قضاها الحلم في مخاض عسير، أعقبها ولوج هذا الحلم لدفّة الواقع ولأول مرة ' حصلتُ على فرصة للعمل في مهنة صفّ الحروف في صحيفة الشاهد الأسبوعية،، وسرعان ما حزتُ على ثقة ناشرها العمّ (أبو معاذ) ممّن منحني سريعا ترقية وظيفية بأن مكنني من العمل كمخرج صحفي، ولأصبح بعدها رئيسا لقسم الإخراج الصحفي في 'الشاهد'، كما كان لعملي لدى أستاذي 'صخر أبو عنزة' فضل كبير عليّ لجهة حصولي على خبرة في فن الكتابة الصحفية،، ولأتقلد لاحقا منصب مدير وكالة رمّ الإخبارية'.
خلال عمله في 'الشاهد'، حصل شادي على فرص إضافية للعمل في صحف أخرى كالهلال والأنباط، والاعلام البديل، وسرعان ما حقق حلمه لجهة تأسيس مشروعه الإعلامي المستقلّ، وكان ذلك من خلال إشهاره لوكالة (عمان جو)الإخبارية، كما أشهر مجلة' الخزنة' الإقتصادية الورقية. وللغرابة أن النجاح الكبير الذي حققه مؤخرا ويحصد جناه اليوم، بما حوّله إلى واحد من أبرز المنافسين في الإعلام الإلكتروني المحلي،، لم يفلح في إخماد نيران الحزن التي استوطنت روحه، فشغلتها بحالة مستعصية من إنعدام السكينة ' الفضلُ لله، ومن بعده لوالديّ في كل ما حققته،، لكنني لا زلت عاجزا عن تلمّس الفرح،، فآلآم الماضي تباغتني لتقطع عليّ وصلته كلما اقترب مني وحاول مهادنتني،، ذلك الفرح الذي عاداني صغيرا،، فخاصمته كبيرا،، والمضحك المبكي هو أنني أخجل من شادي الصغير الشقي حين أحاول إنكاره بملذات وأفراح تيسرت لي أخيرا، وبنشوة وفرتها لي ظروف النجاح وخُطى الوصول،، خطوات تسير بي في ليلي إلى الخلف السحيق،، أختلي بنفسي مع مشاهد تدمي قلبي،، ولتخذلني رجولتي في صدّ ثورة دموعي السخية وأنا أعاود إجترارها'.

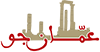


 الرد على تعليق
الرد على تعليق